الثورة الصامتة: الذكاء الاصطناعي يحوّل العالم إلى أغنياء أكثر وفقراء أذكى لكن “مهمَّشين”
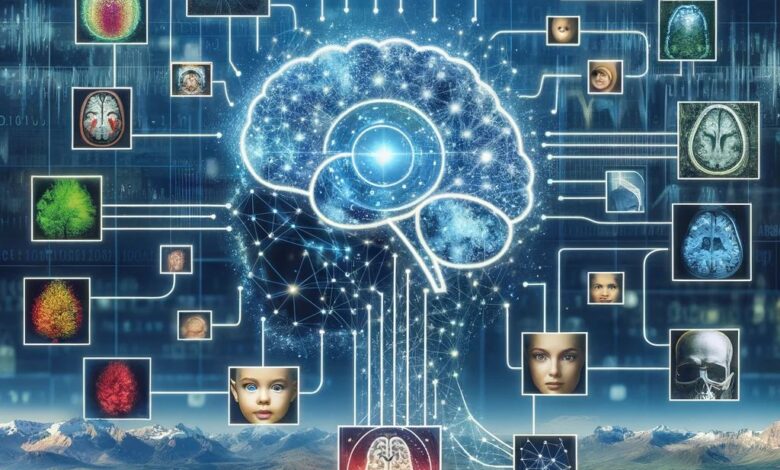
نيويورك – زينة بلقاسم – ألأمم المتحدة
بينما تنشغل دول العالم بسباق تطوير الذكاء الاصطناعي واعتماده في كل تفاصيل الاقتصاد والحياة اليومية، يأتي تقرير جديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليضع فرامل قوية على هذه الحماسة، محذرًا من أن هذه التكنولوجيا التي تُقدَّم غالبًا بوصفها فرصة تاريخية للتنمية، قد تتحول -إذا تُركت من دون إدارة واعية- إلى محرّك لـ “حقبة تباعد جديدة” بين الدول الغنية والفقيرة، وهو ما سيعيد رسم الخريطة التنموية للعالم على نحو يُشبه ما حدث إبان الثورة الصناعية الأولى.
ينطلق التقرير الذي يحمل عنوان “التباعد العظيم التالي: لماذا قد يوسّع الذكاء الاصطناعي الفجوة بين الدول؟” من فكرة بسيطة في ظاهرها، عميقة في مضمونها: الدول لا تبدأ سباق الذكاء الاصطناعي من خط انطلاق واحد. اذ أنه هناك دول تمتلك بنية تحتية رقمية متقدمة، وشركات تقنية عملاقة، وجامعات ومراكز أبحاث، وقدرات هائلة في الحوسبة والبيانات، ودول أخرى ما تزال تكافح لتأمين الكهرباء المستقرة والإنترنت الأساسي وتعليم رقمي أولي لمواطنيها. وعندما تُطرح تقنية ذات أثر شامل مثل الذكاء الاصطناعي فوق هذا الواقع غير المتكافئ، فإن النتيجة المرجَّحة -كما يرى معدّو التقرير- ليست تقليص الفجوة، بل توسيعها، ما لم تُتَّخذ سياسات متعمدة للحد من ذلك.
المفارقة أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي يسميها التقرير “مركز ثقل” انتقال الذكاء الاصطناعي، تجسد هذه الثنائية بكل وضوح. فالمنطقة تضم أكثر من 55% من سكان العالم، وأكثر من نصف مستخدمي أدوات الذكاء الاصطناعي، وتشهد طفرة لافتة في الابتكار: الصين وحدها تقف وراء ما يقارب 70% من براءات اختراع الذكاء الاصطناعي عالميًا، وهناك أكثر من 3,100 شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تأسست في ست اقتصادات فقط من اقتصادات المنطقة. بحسب بعض التقديرات التي يستند إليها التقرير، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يرفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنحو نقطتين مئويتين سنويًا، وأن يزيد الإنتاجية بما يصل إلى 5% في قطاعات مثل الصحة والتمويل، وأن يضيف لما مجموعه دول “آسيان” وحدها نحو تريليون دولار من الناتج خلال عقد واحد.
لكن الصورة ليست مشرقة بالقدر نفسه عندما ننظر إلى الجهة الأخرى من المعادلة. فالتقرير يذكّر بأن ربع سكان آسيا والمحيط الهادئ تقريبًا لا يملكون أصلًا اتصالًا بالإنترنت، وأن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي يصل في بعض الاقتصادات عالية الدخل إلى اثنين من كل ثلاثة أشخاص، بينما يقترب في كثير من الدول منخفضة الدخل من 5% فقط. ومعنى ذلك أن الفرص التي يتحدث عنها المتحمسون للذكاء الاصطناعي -من تشخيص طبي أدق، إلى تحسين الإنتاج الزراعي، إلى خدمات حكومية أسرع- قد تبقى في كثير من الحالات حكرًا على من يملك الاتصال والبنية التحتية والمهارات، بينما يبقى الآخرون خارج اللعبة، أو في أفضل الأحوال في هامشها الضيق.
يولي التقرير اهتماما خاصًا للفئات الأكثر عرضة للتهميش داخل الدول نفسها: النساء، والشباب، والفئات الريفية والمجتمعات المحلية الأصغر. فهو يشير إلى أن الوظائف التي تشغلها النساء في المنطقة تكاد تكون ضعفي الوظائف التي يشغلها الرجال من حيث التعرض لمخاطر الأتمتة، وأن معدلات توظيف الشباب في الوظائف عالية التعرض للذكاء الاصطناعي بدأت بالفعل في التراجع، خصوصًا للفئة العمرية بين 22 و25 عامًا، أي في بدايات المسار المهني. وفي جنوب آسيا، تبقى النساء أقل من الرجال بنسبة تصل إلى 40% من حيث امتلاك هاتف ذكي، ما يعني أنهنّ يدخلن إلى عالم الذكاء الاصطناعي من موقع متأخر أصلاً. أما المجتمعات الريفية والسكان الأصليون، فيشير التقرير إلى أنهم غالبًا غير ممثلين في مجموعات البيانات التي تُدرَّب عليها النماذج، الأمر الذي يرفع من خطر التحيز الخوارزمي وإقصائهم من الخدمات التي تعتمد على هذه النماذج.
في مقابل هذا الوجه القاتم، يعرض التقرير نماذج لما يسميه “الوجه الإيجابي” للذكاء الاصطناعي عندما يُستخدم في خدمة الإدارة العامة والحوكمة. ففي بانكوك، مثلًا، عالجت منصة “ترافي فونديو” مئات آلاف البلاغات من المواطنين، ما سمح لبلدية المدينة بالتعامل مع مشكلات الحياة اليومية -من حفر الطرق إلى إنارة الشوارع- بطريقة أسرع وأكثر شفافية. وفي سنغافورة، خُفِّض الزمن الذي يقضيه الوالدان الجدد في إنجاز معاملات طفلهم الأول من نحو 120 دقيقة إلى 15 دقيقة عبر خدمة رقمية ذكية تجمع البيانات من جهات مختلفة. وفي بكين، تُستخدَم نماذج “التوأم الرقمي” في التخطيط العمراني وإدارة الفيضانات. وتُظهر هذه الأمثلة، في رأي معدي التقرير، أن الذكاء الاصطناعي ليس قدرًا سلبيًا بالضرورة، وأنه قادر -إذا توفرت الإرادة السياسية والقدرات التقنية- على تحسين حياة الناس وخفض كلفة البيروقراطية وتعزيز كفاءة الخدمات العامة.
لكن ومع ذلك، يعترف التقرير بأن عدد الدول التي تمتلك أطرًا تنظيمية شاملة للذكاء الاصطناعي ما يزال محدودًا، وأن أكثر من 40% من خروقات البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بحلول 2027 قد تأتي من سوء استخدام النماذج التوليدية، ما يسلط الضوء على ثغرة هائلة في جانب الحوكمة والمساءلة. وهنا يقدّم “فيليب شيلكينز”، كبير الاقتصاديين في مكتب “يو-ان-دي-بي” لآسيا والمحيط الهادئ، ما يمكن اعتباره “الخلاصة” من وجهة نظر التقرير “خط الصدع” أو خط الانقسام الأساسي في عصر الذكاء الاصطناعي هو «القدرة»؛ من يمتلك القدرات في البنية التحتية والمهارات والحوسبة والحوكمة سيستفيد، ومن لا يمتلكها سيجد نفسه متروكًا وراء الركب.
إلى هنا تبدو الحجة التي يطرحها التقرير متماسكة: لدينا تقنية قوية جدًا وواسعة الأثر، تُطرَح فوق عالم غير متكافئ أصلاً؛ فكيف نتوقع إلا أن تضخم التفاوت ما لم نتدخل سياسيًا وتشريعيًا وماليًا؟ لكن السؤال الذي يطرحه كثيرون في الجهة المقابلة هو: هل هذا التوصيف دقيق بالضرورة؟ أم أن هناك جانبًا آخر للقصة يمكن أن يجعل الذكاء الاصطناعي عامل تقليص للفجوة لا توسيعها؟
ويستند أنصار الرؤية التي يتبناها التقرير إلى ماضٍ ليس ببعيد. فخلال نصف القرن الأخير، شهد العالم ما يسميه الاقتصاديون “حقبة تقارب”؛ إذ استطاعت دول نامية عديدة أن تقلص الفجوة بينها وبين الدول الغنية عبر الاستفادة من التجارة العالمية، ونقل التكنولوجيا، وسلاسل التصنيع العابرة للحدود. والآن، يخشى هؤلاء أن الذكاء الاصطناعي قد يقطع هذا المسار، لأن السيطرة على العناصر الأساسية لهذه التقنية -من الشرائح الإلكترونية المتقدمة، إلى مراكز البيانات العملاقة، إلى فرق البحث والتطوير عالية الكلفة- تتمركز في حفنة من الدول والشركات، بينما يُترَك للبقية دور “مقدمي البيانات” أو “عمال الوسم الرقمي” بأجور منخفضة، كما تشير بعض الدراسات.
و بالتالي ترى هذه الرؤية أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة جديدة، بل بنية تحتية معرفية واقتصادية كاملة. من يمتلكها يتحكم في إيقاع الابتكار، وفي شروط الوصول، وحتى في اللغة والرواية والمعرفة نفسها، ومن لا يمتلكها يتحول إلى “مستهلك” أو “سوق” أو “مورد بيانات” أكثر منه شريكًا. ومن هنا تأتي تحذيرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن عدم التدخل قد يقود إلى “تباعد عظيم” جديد، شبيه بما حدث في القرن التاسع عشر حين استفادت أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية من الثورة الصناعية، بينما ظلت أجزاء واسعة من العالم خارج هذا المسار لعقود طويلة.
لكن على الجانب الآخر، يقدّم بعض الخبراء والباحثين في اقتصاد التنمية والذكاء الاصطناعي رواية مختلفة أو على الأقل أكثر توازنًا. و لا ينكر هؤلاء المخاطر التي أشار إليها التقرير، لكنهم يحذرون من تحويلها إلى “نبوءة مكتفية بذاتها”، أي إلى خطاب متشائم يفترض أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي حتمًا إلى زيادة الفجوة، في حين أن النتائج الفعلية تعتمد إلى حد كبير على الخيارات السياسية والتقنية التي سنتخذها في السنوات القليلة المقبلة.
و يذكّر أصحاب هذا الاتجاه بأن تقنيات رقمية سابقة -مثل الهواتف المحمولة، والإنترنت اللاسلكي، والخدمات المصرفية عبر الهاتف- سمحت لدول نامية عدة بـ”القفز” فوق مراحل تقليدية من البنية التحتية، وتقديم خدمات لم تكن ممكنة بمواردها السابقة. ويستشهدون بأبحاث تظهر أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم إيجابًا في تحقيق غالبية أهداف التنمية المستدامة إذا استُخدم بطريقة واعية؛ إذ تشير دراسة منشورة في 2019 إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم التقدم في 128 هدفًا فرعيًا من أهداف التنمية المستدامة الـ 169، رغم أنه قد يعيق 58 هدفًا آخر إذا أسيء استخدامه أو تُرك بلا ضوابط.
ومن هذه الزاوية، يبدو الذكاء الاصطناعي أقرب إلى “مكبر صوت” منه إلى فاعل مستقل: هو يضخم ما هو قائم. فإذا كانت لدى دولة ما مؤسسات قوية، وبنية تحتية رقمية مقبولة، واستثمار في التعليم والتدريب، فإن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعدها على تسريع النمو وتحسين الخدمات وتقليص الفقر. أما إذا كانت هذه الأسس ضعيفة، فإن التقنية قد تتحول إلى أداة لزيادة البطالة، وتعميق التحيز، وتهميش الفئات الأضعف. وبالتالي، فإن القول إن الذكاء الاصطناعي “سيزيد التفاوت” أو “سيقلله” من دون تحديد السياق وسياسات المواكبة، هو تبسيط مخلّ.
هناك أيضًا من ينتقد التقرير من زاوية أخرى، فيشير إلى أن الحديث عن “فجوة بين الدول” يخفي أحيانًا فجوات أكبر وأخطر داخل الدول نفسها. فحتى في البلدان الغنية، هناك مناطق وأحياء وفئات اجتماعية تكاد تكون غير مستفيدة من ثمار الرقمنة السابقة، فكيف بثورة الذكاء الاصطناعي القادمة؟ وعلى العكس، في بعض الدول متوسطة الدخل تظهر طبقات من الشباب ورواد الأعمال قادرة على بناء شركات ومنتجات تعتمد على نماذج مفتوحة المصدر، مستفيدة من انخفاض كلفة الوصول إلى النماذج الأساسية التي تُطرح بشكل مجاني أو شبه مجاني، ما يفتح الباب أمام نوع من “الابتكار من الأطراف”. من هذه الزاوية، ليست الصورة مجرد دول غنية تستفيد ودول فقيرة تتفرج، بل شبكة أكثر تعقيدًا من علاقات القوة والفرص.
مع ذلك، عندما نسأل: هل ما يقوله التقرير «صحيح» أم «مبالغ فيه»؟ لا يمكن إعطاء إجابة ثنائية بسيطة. ما يبدو راسخًا في الأدبيات البحثية المستقلة، قبل تقرير “يو-ان-دي-بي” وبعده، هو أن الذكاء الاصطناعي يحمل بالفعل خطر تعميق الفوارق القائمة، سواء بين الدول أو داخلها، إذا لم تُستثمر موارد حقيقية في البنية التحتية الرقمية، والتعليم، وبناء القدرات، والحوكمة، والتنظيم. والأمثلة على مخاطر سوء الاستخدام -من التزييف العميق، إلى حملات التضليل، إلى الاستخدام العسكري الأمني غير المنضبط، إلى استهلاك الطاقة والمياه في مراكز البيانات- حقيقية وليست افتراضية.
في المقابل، ما لا يدعمه الدليل حتى الآن هو أن الذكاء الاصطناعي “محكوم” بأن يقود إلى تباعد جديد، أو أن مسار التاريخ مكتوب سلفًا في هذا الاتجاه. فيختار التقرير نفسه صيغة حذرة: “قد” يوسع الفجوة، “إذا تُرك بلا إدارة”، و”من دون سياسات قوية”؛ أي أنه يشير إلى خطر مشروط، لا إلى نتيجة حتمية. ومن هنا يمكن القول إن قوّة التقرير ليست في كونه حكمًا نهائيًا على مستقبل الذكاء الاصطناعي، بل في كونه جرس إنذار مبكر يدعو إلى بعض الخطوات الواضحة: استثمار أكبر في البنية التحتية الرقمية في الدول الفقيرة؛ تمويل جدي للتعليم والتدريب في المهارات الرقمية؛ بناء أطر تنظيمية تحمي الخصوصية وتمنع التمييز وتواجه خروقات البيانات؛ وتشجيع نماذج للتعاون الدولي في نقل التكنولوجيا والمعرفة بدل احتكارها.
في النهاية، يمكن النظر إلى التقرير بوصفه صراعًا بين احتمالين كبيرين: عالم يسمح فيه الذكاء الاصطناعي لدول الجنوب العالمي بتجاوز بعض القيود التقليدية، من خلال تحسين الزراعة والصحة والتعليم والإدارة العامة، وعالم آخر يستخدم فيه الذكاء الاصطناعي لترسيخ تفوق من يملك القدرة والموارد، وترك الآخرين على هامش اقتصاد قائم على الخوارزميات. أي من هذين العالمين سيتغلب ليس مسألة تقنية بحتة، بل قرار سياسي وأخلاقي، يتخذ في وزارات المالية والتعليم والطاقة والاتصالات بقدر ما يتخذ في مختبرات الشركات الكبرى. وإذا كان التقرير محقًا في شيء، فهو أن تجاهل هذا النقاش الآن هو الخيار الوحيد الذي يكاد يكون مضمونًا ليدفع العالم نحو “تباعد عظيم” جديد، لا لأن الذكاء الاصطناعي شرٌّ في ذاته، بل لأنه، مثل كل تقنية قوية سبقت، يميل إلى خدمة من هو مستعد له، وإهمال من لم يستعد بعد.





