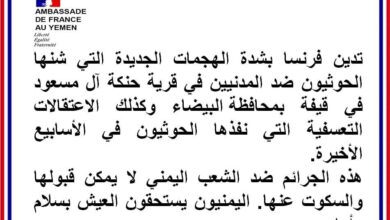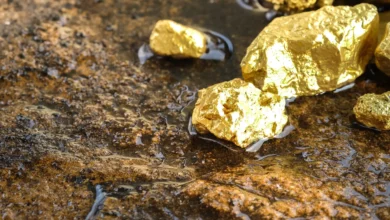أفول نجم فرنسا في أفريقيا

نيويورك – زينة بلقاسم – ألأمم المتحدة
لم يعد تراجع النفوذ الفرنسي في أفريقيا خبرًا عابرًا في شريط المتابعة، بل تحوّل إلى مسارٍ متراكمٍ يمكن تتبعه بالوقائع والخرائط: اجبار بالانسحاب، وتسليم قواعد، وإعادة صياغة لشكل الحضور من قواعد دائمة إلى شراكات أخفّ وأقلّ انكشافًا. ففي الساحل وغرب أفريقيا، تَشابكت ثلاثة عوامل لتُنتج لحظة الأفول، حيث تصاعد الحساسية الشعبية ضد الإرث الاستعماري، و انقلابُ نُخبٍ عسكرية جديدة على الترتيبات القديمة، وتراجع قدرة باريس على فرض روايتها الأمنية بوصفها ضامن الاستقرار. لذلك لم يكن إنهاء عملية “برخان” حدثًا تقنيًا؛ بل علامة على انتقال فرنسا من هندسة المشهد إلى التكيّف معه. وقد أعلن الرئيس الفرنسي رسميًا نهاية العملية في نوفمبر ٢٠٢٢. 
ثم جاءت الوقائع تُكمّل السرد. بعد انقلاب النيجر، أعلن الرئيس ماكرون سحب السفير والقوات الفرنسية من البلاد، في اعترافٍ عملي بأن باريس لم تعد قادرة على البقاء وفق شروطها القديمة.  وفي السنغال، سلّمت فرنسا آخر قواعدها وأنهت وجودًا عسكريًا دائمًا امتد عقودًا، في خطوة وُصفت بأنها نهاية حضورٍ طويل بدأ منذ الاستقلال. ولا تُقرأ هذه التحركات بوصفها انسحابًا كاملًا من القارة، لكنها تُشير إلى انحسارٍ واضح في غرب أفريقيا، مع إعادة تموضع نحو صيغ أقلّ احتكاكًا وأكثر مرونة.
لكن يسأل الكثير، لماذا يتزامن هذا الأفول الأفريقي مع بقاء فرنسا قوة اقتصادية متقدمة عالميًا؟ هنا تكمن المفارقة التي تطلبتَ إضافتها ففرنسا و رغم أنها ليست دولةً تقوم صناعتها على وفرة موارد طبيعية ضخمة، لكنها لا تزال ضمن الاقتصادات الكبرى عالميًا وفق تقديرات صندوق النقد الدولي بفضل نموذجٍ صناعي وخدمي عالي القيمة يتمثل في صناعة الطيران والدفاع والفضاء، و الصناعات الدوائية، السلع الفاخرة، و الزراعة المتقدمة، والخدمات والتمويل والسياحة. كما أن ميزة فرنسا التنافسية الأشد صلابة في العقدين الأخيرين كانت الطاقة منخفضة الكربون عبر الأسطول النووي، ما منحها قدرة تشغيل صناعي واستقرارًا نسبيًا في الكهرباء مقارنةً بكثير من جيرانها: ففي ٢٠٢٤ شكّلت الطاقة النووية نحو ثلثي توليد الكهرباء تقريبًا، وارتفع الإنتاج النووي والكهرومائي بما خفّض واردات الكهرباء بشدة.  هذه هي القوة الهادئة التي تُسند الاقتصاد الفرنسي ليست خامًا يُستخرج، بل منظومات قيمة تُصنَّع وتُصدَّر وتُسوَّق عالميًا.
أما في أفريقيا، فالمعادلة مختلفة، فالقوة الفرنسية هناك كانت تاريخيًا مزيجًا من الأمن والعملة والنخبة والعقود. ومع صعود خطاب السيادة في الشارع، صار الوجود العسكري الفرنسي موضوعًا للاشتباك الرمزي قبل أن يكون ملفًا أمنيًا. حيث تتهم قطاعات شعبية وبعض قوى سياسية في دول الساحل باريس بأنها تُطيل أمد الأزمات تحت لافتة محاربة الإرهاب، وبأنها تتدخل سياسيًا لصالح ترتيبات موالية، بينما تنفي فرنسا هذه الاتهامات وتؤكد أن وجودها كان بطلب من حكومات شرعية وبهدف مكافحة الجماعات المسلحة وحماية المدنيين. وما يمكن تثبيته بالوقائع الموثقة هو أن شرعية الوجود تآكلت، وأن الحكومات الجديدة في أكثر من بلد أنهت أو قيّدت الاتفاقيات، وأن باريس نفسها باتت تتحدث علنًا عن أن جوهر أجندتها في العلاقة مع أفريقيا اقتصادي وأن نفوذها لا يُختزل في القواعد العسكرية، في محاولة لإعادة تعريف الدور بعدما أصبح العسكر عبئًا سياسيًا. وورد عن الخطاب الفرنسي الرسمي، في أزمات مثل النيجر وحماية البعثات والمواطنين، شددت فرنسا على ضرورة حماية المصالح والبعثات واتخاذ ما يلزم ضمن الأطر القانونية والسيادية، وأن التوترات الشعبية والقطيعة مع سلطات جديدة دفعت باريس إلى قرارات انسحاب فعلية بدل التصعيد. 
الخلاصة الاستراتيجية: أنّ فرنسا لم تسقط اقتصاديًا كي تفقد أفريقيا؛ بل العكس: فرنسا ظلت قوية اقتصاديًا عبر صناعات عالية القيمة وطاقة كهرباء منخفضة الكربون، بينما تراجع نفوذها الأفريقي لأن أدواته القديمة المتمثلة المرتكزة على القاعدة العسكرية، ورمزية الحماية، وشبكات النخبة، أصبحت تُنتج كلفة سياسية أعلى من عائدها، في زمنٍ تصعد فيه السيادة كشعار انتخابي وشعبي. وبينما تتجه باريس لإعادة صياغة وجودها الواجب أن يكون أخفّ وأقل استفزازًا، تتقدم قوى أخرى لملء الفراغ بعقودٍ واستثماراتٍ ودعم أمني، وتبقى أفريقيا، لا فرنسا، أمام سؤال أصعب: كيف تُترجم السيادة إلى أمنٍ وتنمية، لا إلى
تبديل تبعيةٍ بتبعية؟